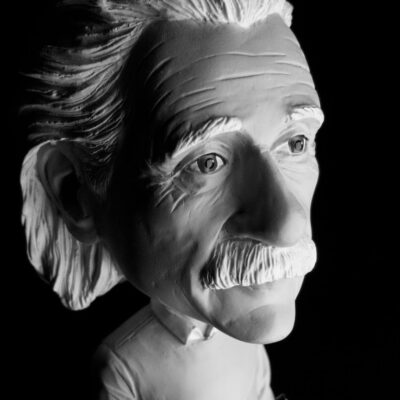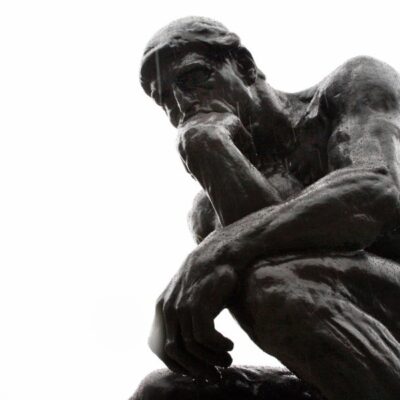ما الّذي جعل جنكيز خان ناجحًا جدًّا؟
أسماءٌ قليلةٌ في سجلّات التّاريخ يُمكنها أن تثير نفس القدَر من الرّهبة والخوف الّتي يبثّها اسم جنكيز خان. وذلك لسببٍ وجيه؛ فقد كان بلا شكّ أعظم غازٍ في التّاريخ، إذ بنى أكبر إمبراطوريّة قارّيّة شهدها العالم انطلاقًا من مجموعة قبائل بدويّة مُتناحِرة في آسيا الوسطى.
تلك ليست سيرة ذاتيّة يُمكن الحصول عليها بُمجرَّد الحظّ؛ إذًا، ما الّذي جعل جنكيز وجيشه ناجحين بشكل مُذهل؟ الحقيقة أعقد ممّا قد تتصوّر.
آلة الحرب
كان مُقدّرًا لجنكيز خان منذ لحظة ولادته أن يكون عظيمًا. على الأقلّ، هذا ما يقوله مُعظَم كُتَّاب سيرته الذّاتيّة المُعاصرين (ولماذا قد يكذبون؟): وفقًا لأقدم عمل أدبيّ باللّغة المنغوليّة، “التّاريخ السّرّيّ للمغول”، لقد وُلِدَ مُمسِكًا بجلطة دمويّة، وهي علامة مؤكّدة على أنّه سيُصبح محاربًا شجاعًا.
لكن قبل أن يُصبح جنكيز خان – عندما كان فقط تيموجين، يتيم الأبّ عديم القَبَيلة الّذي عاش في السّهوب المنغوليّة يبحث عن التّوت ويصطاد الفئران والطّيور – لم يكن أحد يتوقّع كيف ستنتهي قصّته.
فكيف انتقل إذًا من طرفٍ لآخر؟ كان ذلك بدايةً من خلال إقامة تحالُفات ذكيّة – وأولى تلك التّحالُفات كانت مع زوجته الأولى، بورتي. والتّحالف الثّاني، تشكّل بعد اختطاف بورتي من قِبَل قبيلة مُنافِسة، وكان مع خان قويّ آخر يُدعى: توغرول.
أصبحَ لدى تيموجين الآن جيش، وكما كان على وشك أن يثبِت، كان لديه حسّ شبه خارق في كيفيّة استخدامه.
يقول المؤرّخ العسكريّ ريتشارد غابرييل في كتابه “أعظم جنرال لجنكيز خان: سوبوتاي الشُّجاع” الّذي صدرَ عام 2006 م: “كانت قوّة الجيش المغوليّ تكمن في قدرته على تنفيذ العمليّات القتاليّة بكفاءة وفعاليّة تفوق قدرات أعدائهم على المقاومة”.
ويوضح: “يبدو أنّ المغول كانوا أوّل جيش يفهم القيادة العسكريّة بطريقة تركّز على الأهداف بينما تترك اختيار الوسائل لقادة الوحدات القتاليّة”، لقد تمّ التّركيز على المبادرة والابتكار والمرونة في التّنفيذ “.
كان الجيش تحت قيادة جنكيز خان على تواصل جيّد بنحوٍ غير مُعتاد سواء داخليًّا أو خارجيًّا؛ حيث استخدموا نظامًا مبتكرًا لسُعاة البريد، واعتمدوا على تكتيكات التّخفّي والتّجسُّس. وعندما كان يحين وقت الهجوم، لم يكن العدوّ يعرف ما أصابه، كان المغول أشبه بجنود الصّدمة المُحترفين، يرسلون صفوفًا مُتراصّة مُحكمة من الرّماة على ظهر الخيل – مقاتلين يمثّلون “نقلة نوعيّة في التّكنولوجيا العسكريّة”، وفقًا للمؤرّخ فرانك مكلين.
لم يمضي وقتٌ طويل قبل أن يصبح تيموجين الصّغير حاكمًا لإمبراطوريّة تمتدّ من الصّين إلى إيران، لكن هذا يُفسّر فقط كيف حصل على الأرض؛ وليس كيف احتفظ بها.
طاغية مُحِبّ للخير!
عندما تحكم إحدى أكبر الإمبراطوريّات في تاريخ العالم، ستلتقي بشعوب متنوّعة للغاية. بالنّسبة للعديد من القوى الإمبرياليّة، كان يُنظر إلى هذا على أنّه مشكلة؛ لنتأمّل، على سبيل المثال، التّنصير القسريّ للسّكّان الأصليّين في أمريكا الجنوبيّة والوسطى من قبل الفاتحين الإسبان، أو قانون إبعاد الهنود في الولايات المتّحدة.
قد يفاجئك، بالنّظر إلى سُمعَتِه، أنّ جنكيز خان لم يكن مهتمًّا بمثل هذه الإجراءات العنيفة ضدّ المجموعات العرقيّة المُختلفة!
كتب نورمان نايمارك، أستاذ التّاريخ في جامعة ستانفورد، عام 2017 م في كتابه “الإبادة الجماعيّة: تاريخ عالميّ”:
“كان المغول بشكل عام متسامحين مع الاختلافات الدّينيّة، لذلك شجّعوا التّفاعل بين المجتمعات الغنيّة ثقافيًّا في وسط وجنوب آسيا، وأوروبّا، والشّرق الأوسط. كما أنّهم لم يولوا اهتمامًا كبيرًا للتّمييز العرقيّ أو اللّغويّ، ممّا ساهم في نهاية المطاف بتعزيز التّواصل واختلاط الشّعوب والثّقافات ضمن إمبراطوريّتهم الواسعة”.
تابع نايمارك: “كان العديد من الجنرالات والمسؤولين الأكثر ثقة لدى الخانات يمثّلون مجموعًة متنوّعةَ الجنسيّات والأديان من أوراسيا”.
في الواقع، ما عليك سوى التّفكير في نَسَب السّلالة البارزة الّتي خلّفها جنكيز خان لتدرك كيف اختلط المُحتلّون المغول بحماس مع الشّعوب الّتي غزوها؛ لقد تزوّجوا من السّكّان المحلّيّين، واستأجروا حرَفيّيهم، وأخذوا بنصائحهم العسكريّة، بل واستوعبوا وشجّعوا فلسفة وفنّ الثّقافات الّتي هزموها!
كتب موريس روسابي عام 2002 م، وهو مؤرّخ مُتخصّص في شؤون الصّين وآسيا الوسطى والدّاخليّة من جامعة كولومبيا: “إنّ الصّورة السّائدة عن المغول تشير إليهم كلصوص ناهبين همجيّين يهدفون إلى القتل والدّمار. رغم ذلك، أُولِيَ القليل من الاهتمام للمساهمة الكبيرة الّتي قدّمتها شعوب السّهوب البدويّة هذه كرعاة للفنون خلال القرنين الثّالث عشر والرّابع عشر”.
بعيدًا عن تدمير كلّ ما طالته أيديهم، أشرف جنكيز خان ونسله على بناء مدن وبنًى تحتيّة عظيمة. لقد موّلوا تطوير الطّبّ وعلم الفلك، ورعوا مشاريع هندسيّة طموحة.
أشار روسابي أيضًا إلى أنّهم في مجال الفنون قد شجّعوا المسرح والدّراسات التّاريخيّة: “لقد وظّفوا العلماء الكونفوشيّين والرّهبان البوذيّين التّبتيّين، مُشجّعين على بناء المعابد والأديرة، وكانت لديهم سياسة دعم للتّجارة والحِرَف اليدويّة”. وقال: “رغم وحشيّة حملاتهم العسكريّة، لا ينبغي التّغاضي عن تأثيرهم على الثّقافة الأوراسيّة”.
لقد كانت، وبصراحة، صفقًة أفضل ممّا كان يقدّمه الكثيرون آنذاك – وكانت مُغريًة بشكل خاصّ عند مقارنتها بالبديل؛ وذلك بسبب.
سياسة الاستسلام أو الموت
رغم عقليّة جنكيز خان المُنفتحة، لم تكن لتودّ الوقوع عند جانبه السّيّئ. قاعدته للشّعوب المغلوبة كانت بسيطة وثابتة: إمّا الاستسلام، أو التّدمير.
كتب تشارلز باودِن، الأستاذ الفخريّ للدّراسات المغوليّة في جامعة لندن، ضمن موسوعة بريتانيكا: “كانت المجازر الّتي ارتُكِبَت بحقّ السّكّان المهزومين، وما نتج عنها من رعب، أسلحًة استخدمَها بانتظام. وقد وصِفَت ممارسته المتمثِّلة باستدعاء المُدن للاستسلام، ثمّ تنظيم مذبحة منهجيّة لمَن لم يُذعِنوا لطلبه، بالحرب النّفسيّة… جلبت المقاومة دمارًا مؤكّدًا”.
حقيقًة، كانت السّياسة المغوليّة الّتي تتجلّى في التّدمير الكامل لأرض مَن عارضوهم شديدة للغاية، لدرجة أنّها توصف غالبًا بمعايير اليوم على أنّها إبادة جماعيّة. تُظهِر الحسابات المغوليّة المُعاصِرة لعدد النّاجين في الأراضي المُحتلّة من الشّرق الأوسط أنّ عدد السّكّان الحاليّ يعادل عُشر ما كان متوقّعًا لو لم يصل إليها المغول؛ ويُقال أنّ عدد سكّان المجر والصّين قد تراجع إلى النّصف بسبب احتلالهما. ووفقًا لأحد المبعوثين الأوروبّيّين إلى حفيد جنكيز خان عام 1246 م، تقلّصت كييف بعد أن غزاها المغول من “مدينة كبيرة وكثيفة السّكّان” إلى “تقريبًا… لا شيء، مع وجود نحو مئتي منزل فقط، يعيش سكّانهم في عبوديّة كاملة”.
كانت أراضٍ أخرى مغلوبة أفضل حالًا نوعًا ما، ليس بالضّرورة كثيرًا.
أولئك الّذين حاولوا المقاومة عسكريًّا، وهو عادًة ليس بخيارٍ حكيمٍ – نظرًا لأنّ المغول كانوا عادةً متفوّقين في العدد، والقدرة، والمعدّات – قد تمكّنوا من النّجاة بحياتهم إن رأى فيهم الخانات فائدة، كتب نايمارك: “بمجرّد هزيمة العدو، يُفصَل الرّجال المهزومون إلى مجموعات مُختلِفة، غالبًا ما كان يتمّ إنقاذ الحِرَفيّين ذوي القيمة العالية وإرسالهم إلى العواصم المغوليّة لمزاولة حِرَفِهم.
تُمنَح النّساء والأطفال للجنود المغوليّين كعبيد وزوجات ويُدمَجون في المجتمع المغوليّ، أمّا البقيّة فكانوا يُقتلون، عادةً ضمن مجموعات من الضّحايا يُوكَل بإعدامهم أفراد من جنود المغول “.
إنّ أيّ إهانة طفيفة محسوسة ضدّ شرف المغول كان يُمكن لها أن تكون كافية لإثارة ما يُعتبر اليوم إبادة جماعيّة.
أساسًا، ربّما لن يقتلك المغول بسبب دينك أو عرقك، لكنّهم سيدمّرون كلّ شخص في مدينتك وصولًا إلى قططك وكلابك المحبوبة إن لم تُظهِر لهم الولاء التّامّ، ليس لديك الكثير من الخيارات، أليس كذلك؟
كتب نايمارك: “انتشرت الإمبراطوريّة المغوليّة من خلال الرّعب الخالص، أيّ أمير وأيّ شعب سيكونون على استعداد لمقاومة المغول وهم يعلمون أنّ مصير الإبادة ينتظرهم؟”.
- ترجمة: نِهال عامر حلبي
- المصادر: 1