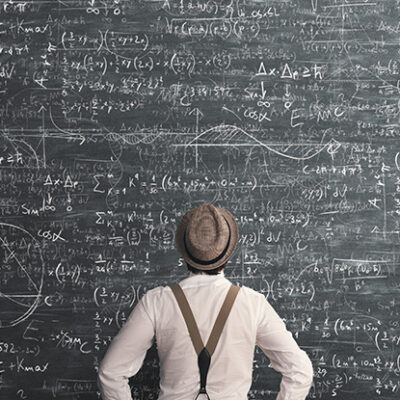تقرير كتاب: التاريخ المدهش غير الدقيق للقياس
يوضح جيمس فنسنت في كتابه “ما وراء القياس” كيف ساهم السعي إلى القياس الكمي في تشكيل التقدم العلمي والمجتمع البشري.
اليوم، نحن نستطيع قياس مدى سخونة أو برودة شيء ما بدقة وبشكل موثوق، ولكن في الواقع ليس لدينا إلا الأدوات والمقاييس لتحديد درجة الحرارة وذلك بعد سلسلة طويلة من التجارب التي أجريت على مدى قرون.
وكما يروي جيمس فنسنت في كتابه الجديد الرائع، “ما وراء القياس: التاريخ الخفي للقياس من الأذرع إلى الثوابت الكمية”، فإن تطوير قياس الحرارة بدأ بالتجربة الإنسانية للحرارة والبرودة. ثم صنع الإنسان أول المناظير الحرارية، وهي أدوات ترتفع وتنخفض فيها السوائل مثل الماء مع تغير درجة الحرارة. هذه التجارب أكدت “الحقائق الواضحة: أن الثلج أبرد من النار، والصيف أكثر دفئاً من الربيع”، كما كتب فنسنت، مراسل The Verge المقيم في لندن.
مع مرور الوقت، ساعدت هذه المناظير الحرارية الأولى في إلقاء الضوء على أفكار جديدة حول درجة الحرارة، مثل ملاحظة عالم الرياضيات الفينيسي جيوفاني فرانسيسكو ساجريدو، وهو أحد معاصري جاليليو وصديقه، في الشتاء “يكون الهواء غالباً أبرد من الثلج، واختلاط الثلج بالملح يجعله أكثر برودة.”.
سمحت هذه النتائج بإضافة علامات رقمية على موازين الحرارة الأساسية. كتب فينسنت: “كانت هذه العلامات اعتباطية وفردية في البداية”، لكن عندما جربها العلماء، تمكنوا من ربط العلامات بنقاط ثابتة سمحت لهم بإنشاء مقاييس درجة حرارة قابلة للتكرار ويمكن مشاركتها. وعلى التوالي، تم تحديد النقاط الثابتة بدقة أكبر، مع بناء كل مرحلة جديدة على أساس المرحلة السابقة. وفي نهاية المطاف، وعلى مدار القرون وعمل مئات العلماء، “تم بناء مقياس موثوق به، درجة بعد درجة، من مقياس الهواء الرفيع”.
يعد تطوير موازين الحرارة ومقاييس درجة الحرارة قصة كلاسيكية للإكتشاف العلمي، مع العديد من التقلبات والتحديات على طول الطريق. على سبيل المثال، قد تبدو نقطة غليان الماء كنقطة ثابتة يمكن بناء مقياس درجة الحرارة عليها، لكن تحديد ما يشكل نقطة غليان الماء لم يكن سهلاً، كما كتب فينسنت. هناك العديد من العوامل التي تؤثر على درجة الغليان مثل الضغط الجوي ونقاء عينة الماء وحتى وعاء الغليان.
ويضيف أن هناك مشكلة التعريفات. “هل يغلي الماء عند ظهور الفقاعات الأولى، أم عندما يتم إنتاجها في تيار مستمر؟” أشار أحد مقاييس درجة الحرارة الذي ابتكره صانع أدوات بريطاني في خمسينيات القرن الثامن عشر إلى هذه المشكلة بعلامات منفصلة للنقطة التي يبدأ فيها الماء بالغليان والنقطة التي يغلي فيها “بشدة”.
وكما اتضح فيما بعد، لم تكن درجة غليان الماء هي العلامة الحرارية الموثوقة التي كان الباحثون الأوائل يأملون بها. في عام 1776، أنشأت الجمعية الملكية فريق عمل لتحديد نقطة الغليان الحقيقية للماء. كان عالم الأرصاد الجوية السويسري جان أندريه دي لوك عضوًا مساهمًا، وقد تناول المشكلة من خلال “مراقبة أوعية الماء المغلي بانتباه وملاحظة سرعة وحجم وصوت تكوين الفقاعات، كوالد ينحني فوق سرير طفله”.
وفي سلسلة من التجارب، درس كيف يمكن للمياه الخالية من الأوكسجين أن تسمح بتسخينها فوق 100 درجة مئوية دون غليان. ولمدة أربعة أسابيع، قام دي لوك بهز أوعية الماء باليد لإزالة فقاعات الأكسجين. حيث روى في أحد التقارير: “أكلت، وقرأت، وكتبت، ورأيت صديقي، وتمشيت، وأنا أهز الماء طوال الوقت”.
لقد شرع في العثور على نقطة الغليان الحقيقية للماء، ولكن بدلاً من العثور على إجابة واحدة لهذا السؤال، وجد دي لوك “عدداً كبيراً من الظواهر التي أجبرت هذا المصطلح المقيد على التجانس”، كما كتب فينسنت:
”لجأ العلماء في نهاية المطاف إلى اعتماد البخار الناتج عن غليان الماء كمقياس أكثر موثوقية لدرجة الحرارة“.
ويشير فينسنت إلى أن الأمر ينطبق على العديد من أنواع القياسات.
“إن البحث عن الدقة -والرغبة في التعمق أكثر فأكثر في الواقع- لا يكشف إلا عن المخالفات على نطاق أوسع بكثير.” ويمكن قول الشيء نفسه عن العلم بشكل عام، وسرد فينسنت لتطور بعض المقاييس العلمية الأكثر استخدامًا هو حكايات كلاسيكية في تاريخ الإكتشافات العلمية. على سبيل المثال، كان المقصود من استخدام وحدة المتر في الأصل قياس المسافة اعتمادًا على خط الطول للأرض، حتى أظهرت المسوحات الدقيقة أن خطوط الطول هذه لم تكن مثالية وثابتة كما كان يُعتقد سابقًا.
يقدّم كتاب “ما وراء القياس” روايات مثيرة للدور الذي لعبه القياس في التقدم العلمي، بما في ذلك أدواره في الطب، والرياضيات، وميكانيكا الكم، ولكن الكتاب يدور حول ما هو أكثر من مجرد علم. يقدم فنسنت أيضًا تاريخًا عميقًا لدور القياس في المجتمع، ويقول: “القياس ليس سمة جوهرية للعالم، بل هو ممارسة اخترعتها وفرضتها البشرية”.
على مدار تاريخ البشرية، كان القياس في كثير من الأحيان بمثابة وسيلة لممارسة القوة. على سبيل المثال، أنشأت الإمبراطورية الرومانية طريقة لقياس الأراضي تسمى سنتورياتيو centuriatio، والتي تقسم الأراضي إلى شبكات. النظام لم يبسّط حقوق الملكية وتحصيل الضرائب فحسب، بل قدّم أيضًا وسيلة لتقسيم الأراضي الزراعية للمحاربين القدامى، وجعل الطرق ملائمة لسير القوات، كما كتب فينسنت: “بعبارة أخرى، ساعد المسح في تمويل، وتوجيه، ومكافأة آلة الحرب في الإمبراطورية الرومانية”.
يكتب فينسنت أنه خلال فترة ما في القرنين السابع عشر والثامن عشر، انتشرت “روح القياس الكمي” في جميع أنحاء السويد وبقية أوروبا. أراد الناس قياس كل شيء، الأرض والسماء والناس وكل شيء بينهما. لم يكن هذا مجرد مسعى فكري فقط، إنما كان له غرض سياسي أيضًا، كما يقول فينسنت: “كان الأمر يتعلق بالسيطرة على الأرض”. ويشير إلى أن “الهوس السويدي بالقياس تزامن مع صعود البلاد إلى مكانة القوى العظمى وفترة التوسع العسكري”.
يكتب فينسنت أنه في السنوات الأولى في الولايات المتحدة، أصبحت سلسلة المساحين “أداة أساسية للعنف الاستعماري”، لأن قياسات الأرض كانت خطوة نحو الاستيلاء على الملكية. إن بساطة مسح الأراضي، إلى جانب “الإشراف والسيطرة التي قدمتها للحكومة الفيدرالية، والتحول النفسي الذي أحدثته في أذهان الناس -عزّز التصور على أن البلاد برية وغير مطالب بها- كل ذلك ساعد المستوطنين ذوي البشرة البيضاء على سرقة الأراضي من سكان القبائل الأصليين”.
وسواء كان ذلك عن قصد أو عن طريق الصدفة، فإن تتبع التدابير يؤدي حتما إلى تغيير السلوك البشري. يقدم فينسنت مثالاً درامياً لما حدث خلال حرب فيتنام عندما قام وزير الدفاع الأمريكي روبرت ماكنمارا بقياس نجاح أمريكا في الصراع وفقاً لعدد مقاتلي العدو الذين قتلوا. يؤكد فينسنت أنه لم يكن إحصاء الجثث وسيلة غير فعالة لقياس التقدم في الحرب فحسب، بل شجع أيضًا على ارتكاب جرائم الحرب. قال أن الضغط لزيادة أعداد الجثث دفع الجنود الأمريكيين إلى القتل بشكل عشوائي والإبلاغ عن كل ضحية فيتنامية على أنها عدو. على الرغم من أن فينسنت لم يذكر ذلك، إلا أن تركيز ماكنمارا على المقاييس القابلة للقياس الكمي أدى إلى ظهور مصطلح “مغالطة ماكنمارا”، والذي يشير إلى خطأ اتخاذ القرارات بناءًا على معلومات يمكن قياسها فقط.
إنها مشكلة يمكن رؤيتها أيضًا في حركة “الذات الكمية” الحديثة، حيث يتتبع الأشخاص العاديون قائمة طويلة من الأشياء القابلة للقياس عن أنفسهم، سعيًا إلى التنوير الذاتي. وتشمل الأشياء التي يتم قياسها بشكل شائع ساعات النوم وعدد الخطوات والسعرات الحرارية، وكلها يتم جمعها بحثًا عن معرفة الذات. يكتب فنسنت أن هذا الاهتمام “لا يكون مركّزًا دائمًا، وفي بعض الأحيان، يبدو أنه يتم قياسه كرد فعل”.
وجد فنسنت في المنتديات عبر الإنترنت متتبعين ذاتيين سجلوا أشياء تافهة مثل العلاقة بين القلق وتكرار التجشؤ، والاتجاه الأساسي الذي واجهوه على فترات منتظمة.
وقال: “من خلال قصر نطاق التحقيق الذاتي على ما يمكن قياسه، يتأكد الممارسون من العثور على إجابات”، مع الإشارة إلى أن هذا النوع من التتبع الذاتي يمكن اعتباره استجابة للثقافة السائدة التي تعمل فيها أنظمة التحكم الرقمية وشبكة مراقبة واسعة تراقبنا دائماً.
يعترف فينسنت بالمخاطر التي يشكلها اختزال الحياة والطبيعة في أرقام، لكنه يشير أيضًا إلى الطرق التي يمكن أن تقودنا بها القياسات إلى جمال وحقائق أكبر. يكتب فنسنت: “على الرغم من أن القياس يتم تصويره على أنه نشاط مفسد يقلل من حيوية العالم إلى مجرد أرقام”، إلا أن العكس يمكن أن يكون صحيحًا أيضًا. إن الحماس لقياس الأشياء بدقة يمكن أن يجبرنا على فحص “زوايا وخبايا الخبرة الجسدية التي ضاعت سابقًا في المشاجرة. كلما نظرنا عن قرب، كلما كشف العالم عن نفسه أكثر.”.
- ترجمة: عبير ياسين
- تدقيق لغوي: سفوك حجي
- المصادر: 1